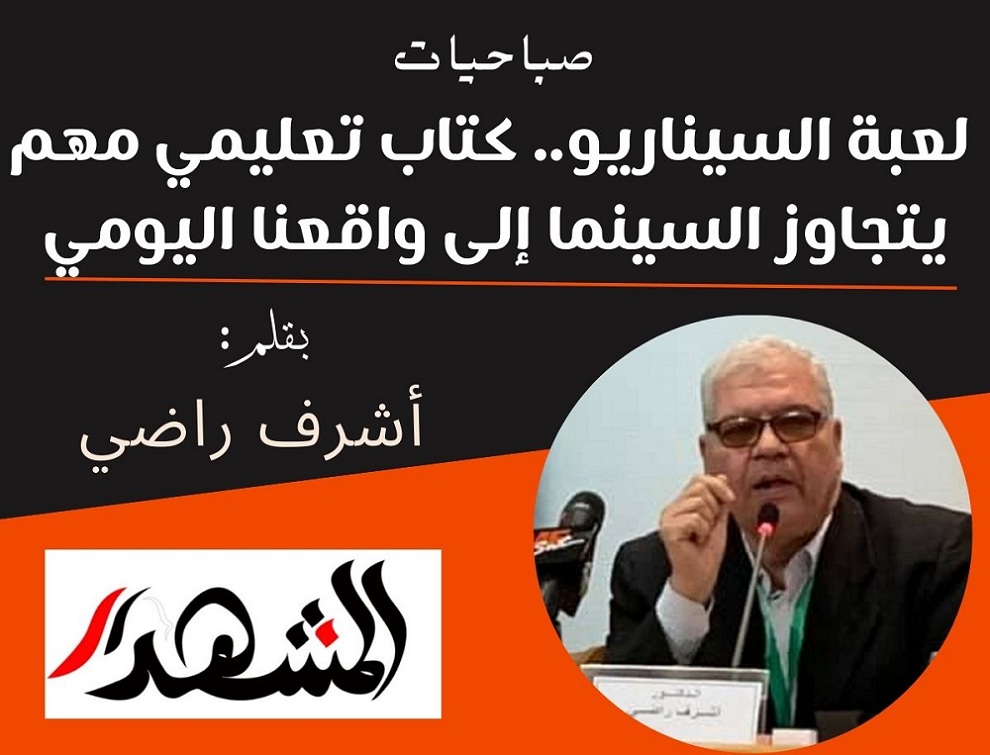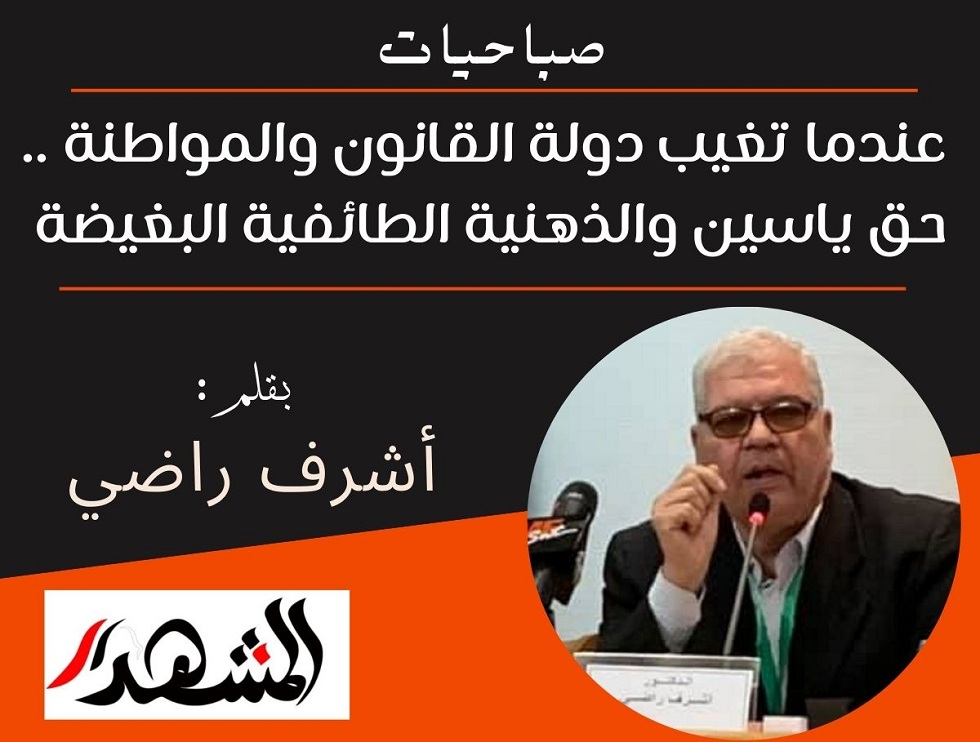لفت انتباهي العبارة التي اختارتها الدكتورة ثناء هاشم، أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، "لا تضع حكاياتك نائمة على الورق" في صفحة الغلافة الداخلية لكتابها "لعبة السيناريو"، الذي صدر مؤخراً وحظي باهتمام إعلامي كبير، وعلى الرغم من أن الناشر غير دون قصدٍ على ما يبدو حكاياتك لتصبح كلماتك على الغلاف الخارجي للكتاب، لكن لا فارق كبير، فالكتاب بالفعل عن الكلمات التي تُصاغ في حكايات بلغة سينمائية، فالكتاب بهذه العبارة الشارحة لا يستقر في مكانه في المكتبة السينمائية بل يبرحها ليصبح كتاباً للجمهور العام أيضاً، دون أن يفقد رصانته الأكاديمية وقيمته الكبيرة ككتاب تعليمي يُدون ما هو مستقر في دراسة فن السيناريو، وهو ما يتضح من تقديم الكتاب الذي استشهدت فيه بقول المخرج الفرنسي الشهير روبير بريسون (1901 – 1999)، إن السينما هي كتابة الغد، وهو ما تأكد بالفعل بعد ظهور السينما، التي زودت الفنون الأخرى من أدب وشعر ومسرح وموسيقى، بوسيلة أخرى مرئية لتحقيق الأحلام التي صنعتها تلك الفنون، نظراً لأنها "ساهمت بشكل حفي وتلقائي في بلورة أشكال لانهائية من الخيال والمفاهيم والأحلام والخرافات والعقائد"، (صفحة 8)، وبهذا تلعب السينما دوراً مهماً في سد احتياج يحقق للإنسان توازنه من خلال الأحلام، أحلام النوم وأحلام اليقظة.
وتضيف الدكتورة ثناء أن حساسية السينما، كفن يندرج في مصاف الدراسات الإنسانية العليا، تكمن في كونها تقدم رؤية للعالم بأسره، وهي "طريقة مدهشة" ليس فقط لفهم الواقع وإنما أيضاً لإعادة بنائه. وهذا الواقع ليس واضحاً على النحو الذي نتوقعه، بل هو غامض وملتبس، وليس له شكل دقيق، وهنا تبرز أهمية السيناريو باعتباره الأساس الذي يقوم عليه الفيلم، والذي قال عنه المخرج البريطاني الأشهر ألفريد هيتشكوك، إنه وحده الضامن الرئيسي للفيلم الناجح. فالسيناريو هو الأداة الأساسية لتحويل أي نص أو فكرة أو معنى إلى لغة يتم ترجمتها على الشاشة في عمل متكامل يعيد بناء الواقع. ولا يقتصر استخدام السيناريو على السينما فقط، فكثيراً ما تُستخدم كلمة "سيناريو" أو "سيناريوهات"، في العديد من التقارير الصحفية والإعلامية التي تتناول الكثير من الأزمات السياسية الدولية والمحلية، للإشارة إلى التصورات المقترحة للخروج من هذه الأزمات والمشكلات، وهو كلمة إيطالية مشتقة من لفظ لاتيني تعني "المشهد المسرحي"، أو بالأدق تعني "بناء المشهد المسرحي"، أو "الفضاء المشهدي"، واستطاعت السينما تحويله لكونها الفن القادر على الجمع بين "لغة الأشياء ولغة البشر".
وتقدم المؤلفة من خلال الكتاب الذي بلغ عدد صفحاته أكثر من 300 صفحة موضوع السيناريو من خلال 26 عنواناً يتناول الأشكال المختلفة للسيناريو والمعالجات الدرامية استهلتها بتقديم انتقلت بعده لتعريف السيناريو والكتابة السينمائية بوصفهما أولى خطوات الخلق الإبداعي. ثم تتناول في جزء كبير من الموضوعات تقنيات كتابة السيناريو وكيفية إعداده سواء للأفلام القصيرة أو الطويلة أو التسجيلية والوثاقية، وعيرها من أنواع مختلفة للفيلم. ويتناول الكتاب عناصر مهمة في العمل السينمائي تتعلق بالبشر (الشخصيات) والأماكن والزمن. واختتمت الكتاب بتقديم سيناريو فيلم بعنوان "مهمة خاصة جداً" كبيان عملي لكل عناصر السيناريو التي تناولتها في الكتاب.
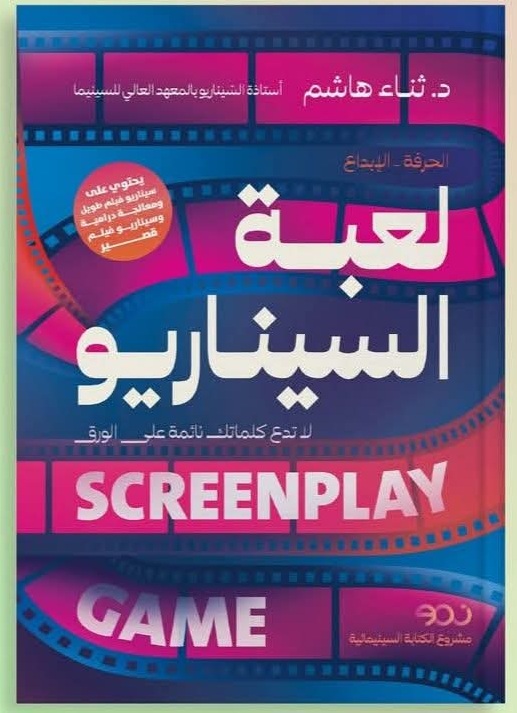
السيناريو جسر بين السينما والواقع
إن السيناريو وغيره من مصطلحات ارتبطت بفن المسرح والسينما من بعده، تطورت بتطور الصناعة واكتسبت معنى اصطلاحيا بات من المتعذر معه العثور على مرادفات له في اللغات الأخرى فجرى نقلها كما هي، وأصبحت من المفردات المستخدمة في العديد من اللغات على النحو تنطق به، مثلها مثل كلمة "سينما" و"فيلم". وتوضح المؤلفة أنه منذ عام 1907، بدأت كلمة سيناريو تظهر بدقة باعتبارها "القصة المعدة للتصوير"، (صفحة 10)، أو "هو نوع من التصميم الأولي المكتوب للفيلم كما ينبغي أن يخرج للمتفرج ويراه" (صفحة 11)، واجتهدت الدكتورة ثناء في هذا الجزء في تمييز السيناريو عن غيره من عناصر بناء الفيلم من كتابة للحوار أو التصوير أو الديكور أو تقطيع الفني للمشاهد (الديكوبلاج) أو تركيبها (المونتاج)، وما يرتبط ذلك من لقطات الترابط والأطر والزوايا وحركات الكاميرا، رغم اعتماد هذه العناصر اعتمادا أساسيا على السيناريو، والتمييز بين دور السيناريو ودور الإخراج في صناعة الفيلم، وتشدد على أن هذا التمييز ضروري ومهم لتصحيح خطأ شائع يقع فيه كتاب السيناريو المبتدئون بتقديم مشاريعهم المكتوبة على شكل التقطيع الفني.
لا أسعى في هذا التقديم للكتاب إلى الاستغراق في شرح نقاط فنية يمكن للقارئ أن يجدها في صفحاته، وإنما الهدف هو الإشارة إلى أهمية الكتاب بالنسبة للقارئ العام، ولعل الجزء الخاص بشرح أفضل شكل لكتابة السيناريو قبل التنفيذ والتعريف بالكتابة السينمائية يحظيان بأهمية خاصة في هذا الصدد، وقد يكون هذا التمييز ضروريا للكتاب الصحفيين والمحللين والإعلاميين الذين يفرطون في استخدام كلمة "سيناريو"، إذ تشير إلى أن الكلمة منذ نشأة السينما باختلاف مدارسها وتقنياتها تنقسم إلى مرحلتين هامتين، هما: "اختراع القصة"، ثم "بناء شكل القصة". وفي هذا الجزء يكتشف القارئ مدى معرفة المؤلفة ودرايتها بفلسفة السينما، التي تراها إعادة لرسم "الأرض التي ينتشر فوقها الالتباس بواقعها التقني والجمالي" منذ اختراعها، إذ أنها "تقوم باستكشاف معنى الواقع وبنائه، والمهم هنا ليس ما نرويه، وإنما كيف نرويه؟ (صفحة 12). هنا تكون السينما أداة سياسية بامتياز، لأنها تمكن المشاهد من "رؤية الواقع معروضاً في صور صارخة بالحقيقة". ويلعب الانفتاح على الأسئلة هنا دوراً مهماً، تماماً مثل الدور الذي يلعبه في الفلسفة. وتقول بشكل واضح "إن تعلم السينما كتعلم الفلسفة، يرشدانك إلى معرفة الذات وإلى التعبير الشخصي الخاص بك" (صفحة 14).
والنصيحة التي يقدمها الكتاب والتي من الممكن أن تكون مفيدة لمن يتحدثون عن سيناريوهات في المجال السياسي يتمثل في عدم الخلط بين العالمين المتلاصقين المندمجين في السيناريو رغم الاختلاف الشديد بينهما، المرتبطة بكيفية بناء الحدث الأساسي كحكاية يتم تصويرها عبر مشاهد متتابعة ومترابطة، محذرة من أن الخلط بين هذا العالمين، وهما: الحدث أو الحبكة أو القصة التي يرويها الفيلم، ثم عملية السرد بغرض تصوير هذه الحكاية. أما كتابة سيناريو لحل أزمة ما يغيب عنه غالباً الشق المتعلق بكيفية لإخراج هذا الحل، وهو تدخل في صميم الفعل السياسي. والفعل، والفعل البشري على وجه التحديد هو القاسم المشترك بين سيناريو يكتب للسينما وسيناريو يكتب في ورقة سياسية، مع الانتباه إلى أن ما يكتب هو "تمثيل" لهذا الفعل البشري، وليس هو الفعل البشري في العالم الواقعي.

السيناريو الحلم والخلق الإبداعي
نأتي للقيمة العملية للكتاب التي تتجاوز قيمته التعليمية الرفيعة وتتجاوز الدروس التي يمكن الاستفادة منها عند كتابة سيناريو لورقة سياسية، وتتمثل القيمة العملية للكتاب في عنوانه "لعبة السيناريو"، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعظم الكتب الأكاديمية هي الكتب التي استطاعت تقديم موضوعها من خلال مفهوم "اللعبة"، إن نظرية المباريات تعد أفضل اقتراب مفهومي لمحاكاة الواقع، ومفهوم الاقتراب ذاته من المفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، فإننا لا نستطيع إدراك الواقع بدقة وإنما نطور أدوات ومناهج للاقتراب من بناء تصور أكثر دقة للواقع مع استعداد دائم لنقد ومراجعة وتعديل ما نكتبه ونبنيه من تصورات، هنا يلعب السيناريو كأداة لمحاكاة الواقع دورا مهماً. وتعد حالة "العمى" هي التعبير الأمثل عن صلتنا بالواقع وحقيقة إدراكنا له، وطرح الأسئلة وإعادة طرحها وحده هو الذي يعصمنا من الركون إلى ما لدينا من تصورات عن الحقيقة، أيضا معرفتنا بالشخصيات التي يتمحور حولها السيناريو تلعب دوراً في بناء السيناريو وهذا يفتح السيناريو على علم النفس للإلمام بالجوانب المختلفة للشخصية الخارجية والداخلية، والتعرف على صراعات الشخصية والتفاعلات الإنسانية، فالسيناريو بهذا المعني معني بالحياة وتفاعلاتها وتشابكاتها المعقدة، وإلمام واسع بالجوانب المختلفة للحياة البشرية.
نأتي هنا لأكثر أقسام الكتاب التي تخاطب القارئ العام والتي تحول السيناريو من موهبة وفن يجيده المحترفون إلى أسلوب حياة وطريقة في التفكير، وتحفز كل فرد على اكتشاف القدرة الكامنة داخله على الإبداع والخلق، وإذا كان البشر يشتركون في فكرة الحلم كنشاط يحدث عفويا وبشكل تلقائي أثناء النوم، أو يمارسونه من أجل بناء عوالم موازية يهربون إليها في فترات اليقظة، ويدركون أنهم يشتركون في تلك القدرة، فإنهم يشتركون أيضا في القدرة على الإبداع أو الخلق، فالإنسان بحكم التعريف هو الكائن الوحيد في المملكة الحيوانية القادر على تصور أشياء من العدم والقادر على التفكير والخلق، لكن إدراكهم لتلك القدرة أو المملكة تتفاوت من شخص لآخر وكثير من الناس لا يتمكنون من إدراك تلك القدرة الكامنة إلا تحت المعاناة أو الحاجة لمواجهة التحديات. ربما كان القسم المعنون "لا تدع حكاياتك نائمة على الورق"، والتي اختارتها المؤلفة عنواناً فرعياً للكتاب هي أكثر أقسام الكتاب صلة بالحياة اليومية للبشر. فكل فرد منا قصة أو حكاية لكن القليل فقط هم القادرين على تحويل تلك القصص والحكايات إلى سيناريو، والقليلون منهم من يستطيع تحويل القصص النائمة على الورق إلى حكايات تمشي ويستطيع الناس رؤيتها، والكتاب يزود القاريء العادي على اكتشاف هذه القدرة الإبداعية الكامنة بداخله، ليس بغرض أن يصبح كاتب سيناريو محترف، وإنما من أجل أن يستطيع ترجمة قصته الخاصة إلى قصة يمكن للناس رؤيتها بوضوح، فالكتب له قيمة عملية أيضا للمشتغلين في كثير من المجالات الأخرى بدءاً بالدعاية والتسويق والصحافة والإعلام والبحوث الاجتماعية إلى من يمارسون السياسة أو العمل العام سواء من خلال الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، لا لشيء إلا لأن السيناريو هو بالفعل "لعبة"، لكنه "لعبة الحياة"، لعبة تتجاوز الشاشة الفضية إلى تفاصيل حياتنا المختلفة، وتظل أعظم الأعمال الفنية في النهاية، هي الأعمال القادرة على تصوير حياة البشر العاديين، وترجمة أحلامهم.
ثمة طريقة مهمة لمن يُقدمون على قراءة الموضوعات المختلفة التي يتناولها الكتاب تتمثل في تطبيق ما يقرؤونه على أعمال سينمائية مختلفة، كيف تتعامل السينما مثلاً مع فكرة المكان وتعيد بنائه وتصويره، والزوايا التي يتم من خلالها تصوير المكان، وكيف تتعامل مع مفهوم الزمان، كيف تختزل أزمنه ممتدة في لحظات قصيرة وكيف تنتقل عبر الزمان في الماضي والحاضر والمستقبل، وكيف تعيد ترتيب الزمان وتدمج الماضي بالحاضر وتطرح تساؤلات خاصة بالمستقبل.
هذا جانب قليل من الجوانب الكثير التي يتضمنها الكتاب الذي يستحق الاهتمام وتستحق مؤلفته كل التحية، لما بذلته من جهده في الرجوع إلى أهم المصادر في موضوعها، والأهم لما بذلته من جهد في بناء موضوعاته وتقديمها فبدا الكتاب شيقاً وبدت قراءته كما لو كنا نقرأ سيناريو أو نشاهده.
--------------------------------
بقلم: أشرف راضي